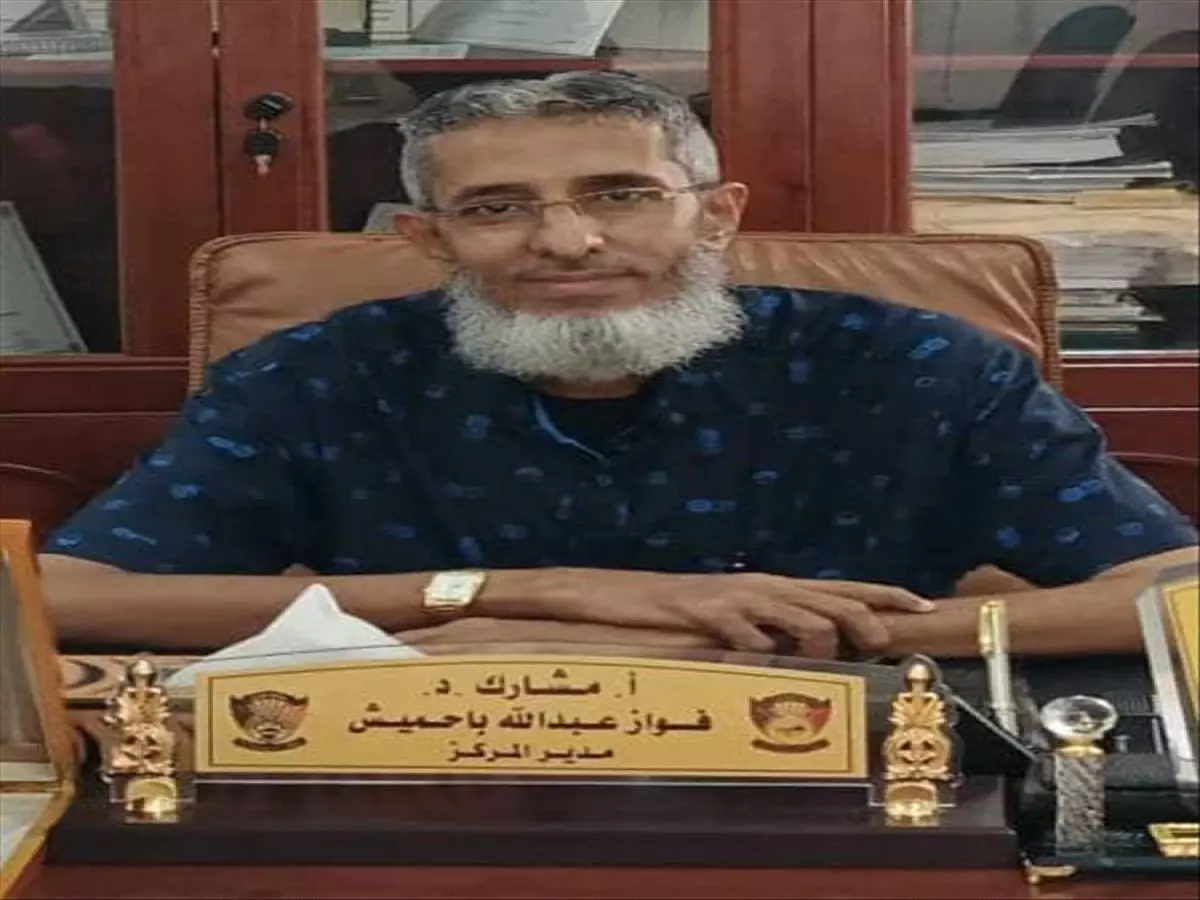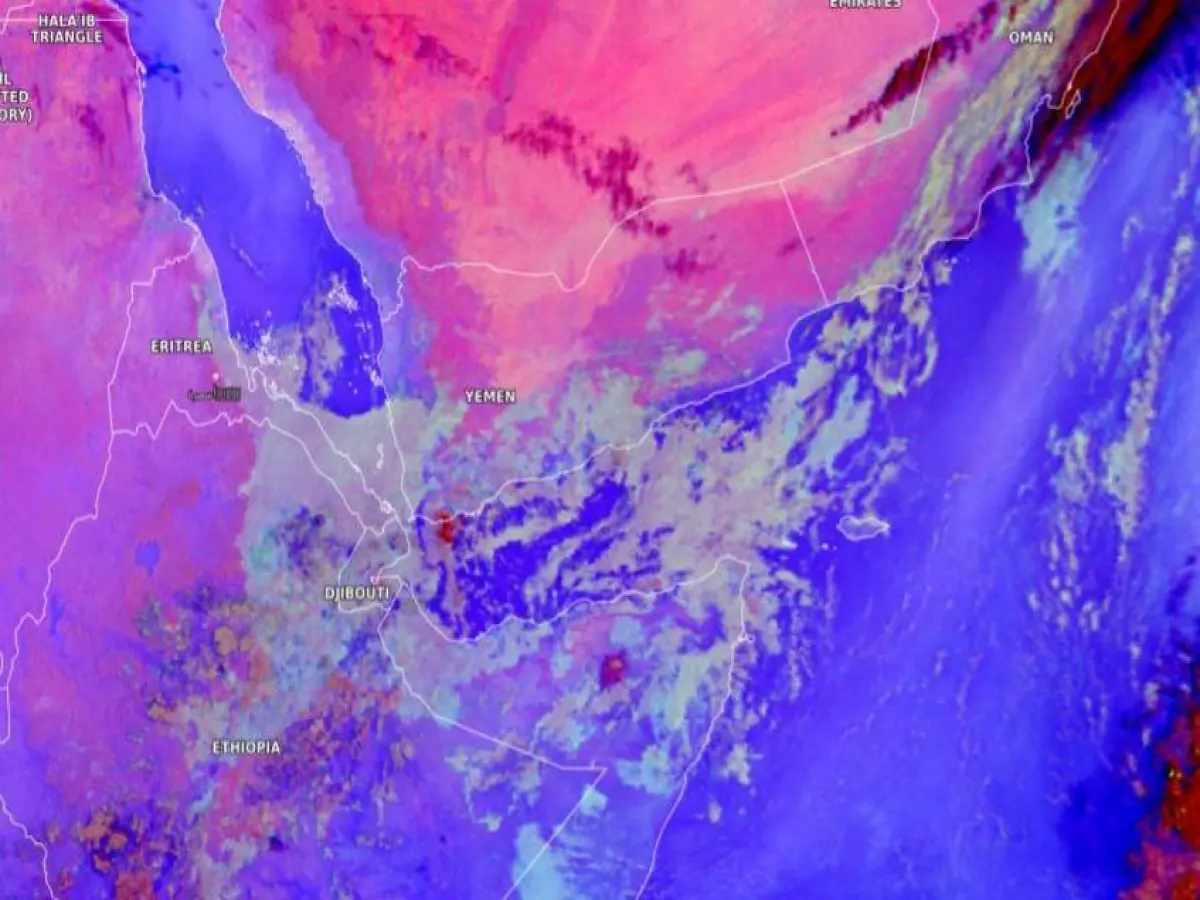في فناء مدرسة حكومية بلحج قرب عدن، تتوارى خيمة مهترئة الأقمشة، وداخلها تجلس المدرّسة سعاد صالح وحولها أكثر من مائة تلميذ يفترشون الأرض. بينما على الضفة الأخرى من المدينة، في مدرسة "الحرم الجامعي" التي شيّدها البرنامج السعودي، يجلس أربعون طالباً على مقاعد معدنية في فصل مجهّز بمراوح وألواح حديثة. الصورة ليست مجرد تناقض بصري، بل تجسيد لسؤال أعمق: هل نحن أمام قصتين مختلفتين للتعليم في اليمن، أم أمام نموذجين لمفهوم الكرامة ذاته؟
رحلة داخل الخيام - قصص الصمود اليومي
في مدرسة "الرباط الغربي" التي تضم 1300 تلميذ، معظمهم نازحون من خارج عدن، يتحوّل التعليم إلى فعل مقاومة وجودية. تعمل سعاد صالح، المدرّسة المنتقبة البالغة من العمر ثلاثين عاماً، براتب شهري لا يتجاوز خمسين ألف ريال يمني، أي ما يعادل ثلاثين دولاراً فقط. هذا المبلغ الضئيل يأتي من تبرعات أولياء الأمور الذين يدفعون ألفي ريال شهرياً – أي دولار وربع – ليضمنوا استمرار تعليم أطفالهم.
المشهد داخل الخيمة يحكي قصة أعمق من مجرد نقص في الإمكانيات. عندما تحتاج سعاد إلى عشر دقائق كاملة لإسكات 110 تلاميذ مكتظين في مساحة ضيقة خانقة، فهي لا تواجه مجرد تحدٍ تعليمي، بل تناضل ضد محو جيل كامل من الوجود. "في هذه الكثافة لن يعرف معظمهم أن يكتبوا أو يقرأوا"، تقول بصراحة مؤلمة تلخّص حجم الكارثة.
في الكرافان المعدني المجاور، يفترش أكثر من ثمانين تلميذاً الأرض، بعضهم حافي القدمين، يتقاسمون الكتب ويحملون حقائب تبرّعت بها جهات خيرية. إنهم محظوظون – كما يصفهم التقرير بمرارة – مقارنة بأربعة ملايين ونصف طفل يمني حُرموا تماماً من دخول أي مدرسة بسبب حرب تجاوزت عقدها الأول.
النموذج البديل - مدرسة "الحرم الجامعي" السعودية
على بُعد كيلومترات قليلة من مشهد الخيام المهترئة، تقف مدرسة "الحرم الجامعي" شاهداً على إمكانية مختلفة للتعليم في اليمن. شيّدها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عام 2023، وتضم أربعة عشر فصلاً دراسياً تعمل على فترتين صباحية ومسائية. كل فصل يحتوي على أربعين طالباً فقط، مقارنة بالمائة والعشرة في الخيام. المقاعد المعدنية المريحة، والألواح الحديثة، والمراوح، كلها تفاصيل قد تبدو بسيطة لكنها تصنع فارقاً جوهرياً في تجربة التعلم.
تشرح فتحية العفيفي، مديرة المدرسة، من داخل مكتبها المؤثث بعناية: "المدرسة التي موّلها البرنامج السعودي مكّنت من استقبال عدد كثير من الطلاب من أماكن بعيدة وخففت الكثافة في مدارس أخرى". الجملة تحمل دلالة أعمق من مجرد توفير بديل تعليمي؛ إنها تتحدث عن كسر دائرة اليأس التي تحاصر آلاف الأسر النازحة.
البرنامج السعودي لم يكتف ببناء المدارس، بل اعتمد نهجاً شمولياً يشمل تأهيل المعلمات. في نهاية أكتوبر الماضي، احتفل البرنامج بتخريج 150 فتاة مؤهلة للتدريس في المناطق الريفية في أربع محافظات يمنية. هذا الاستثمار في الكوادر البشرية يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحدي: ليس الأمر مجرد توفير مبانٍ، بل بناء منظومة تعليمية مستدامة.
يوضح أحمد المداخلي، مدير مكتب البرنامج السعودي في عدن، الرؤية الاستراتيجية وراء هذا الاستثمار: "السعودية ترى التعليم محركاً أساسياً لتنمية المجتمع اليمني". هذا التصريح يكشف عن تحوّل جوهري في نهج المساعدات الخارجية، من الإغاثة الطارئة إلى الاستثمار طويل المدى في رأس المال البشري.
الأرقام تتكلم - حجم الاستثمار والتأثير
عندما نضع الأرقام في سياقها الصحيح، تصبح الصورة أكثر وضوحاً وربما أكثر إثارة للقلق. البرنامج السعودي استثمر في بناء 31 مدرسة منذ إطلاقه، مقابل ثلاثة آلاف مدرسة دُمّرت كلياً أو جزئياً بحسب أرقام اليونيسف لعام 2022. هذا يعني أن جهود إعادة البناء تغطي حوالي 1% فقط من الدمار الحاصل. لكن الأهمية لا تكمن في النسبة المئوية بقدر ما تكمن في نوعية التدخل ونموذجه.
من الناحية الاقتصادية، تكلفة توفير راتب مدرسة متطوعة لمدة شهر (30 دولاراً) تعادل تقريباً تكلفة وجبة واحدة في مطعم متوسط في عاصمة خليجية. بينما تكلفة بناء مدرسة كاملة بأربعة عشر فصلاً يمكن أن تخدم آلاف الطلاب لعقود قادمة. هذه المقارنة تطرح تساؤلاً حول فعالية توزيع الموارد في الاستجابة للأزمة التعليمية.
منذ عام 2018، وفّرت السعودية قرابة 12 مليار دولار كدعم نقدي للمصرف المركزي اليمني ومشاريع في قطاعات النقل والزراعة والصحة والتعليم. هذا الرقم الضخم يضع الاستثمار التعليمي في سياق أوسع من الالتزام طويل المدى بإعادة بناء اليمن. كما يطرح تساؤلاً حول إمكانية تطبيق هذا النموذج على نطاق أوسع لمعالجة أزمة الأربعة ملايين ونصف طفل المحرومين من التعليم.
عمر كريم، الخبير في السياسة السعودية في جامعة برمنغهام الإنكليزية، يسلط الضوء على تحوّل جوهري في نهج المساعدات: "هذا لم يكن الحال تقليدياً، إذ كانت المساعدات تُخصص في المقام الأول لزعماء القبائل لكسب النفوذ السياسي، أما الآن، فمن الواضح أنها تركز على تحسين مؤشر التنمية البشرية". هذا التحليل يكشف عن تطور في مفهوم الاستثمار الخارجي من شراء الولاءات السياسية إلى بناء الاستقرار المجتمعي.
السؤال المفتوح - نحو نموذج مستدام
تحذر فتحية العفيفي من عواقب كارثية لاستمرار أزمة التعليم: "التوقف عن الدراسة له أثر سلبي... جيل كامل لا يقرأ ولا يكتب. هذه كارثة. العالم يتقدّم للأمام ونحن نعود للخلف". هذا التحذير ليس مجرد تعبير عن قلق تعليمي، بل تنبؤ بتداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية قد تمتد لعقود.
إن النموذج المطبق في مدرسة "الحرم الجامعي" يطرح تساؤلات مهمة حول قابلية التطبيق على نطاق أوسع. هل يمكن تعميم هذا النموذج على المناطق الأخرى؟ وما هي الآليات المطلوبة لضمان الاستدامة؟ المحلل عمر كريم يقدم إجابة جزئية: "من المؤكد أن التركيز على التعليم مهم لأنه يمكن أن يحسّن مؤشر التنمية البشرية ويمكن أن يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد اليمني، لكنه يساعد أيضا في إبعاد الشباب عن الحوثيين".
لكن السؤال الأكبر يبقى معلقاً: كيف يمكن التوفيق بين حجم الكارثة التعليمية والموارد المحدودة المتاحة؟ وكيف يمكن ضمان ألا تبقى النماذج الناجحة مجرد واحات في صحراء من الحرمان؟
الخيام المهترئة في "الرباط الغربي" والفصول المجهّزة في "الحرم الجامعي" ليسا مجرد نموذجين مختلفين للتعليم، بل يجسدان رؤيتين مختلفتين للمستقبل اليمني. الأولى تمثل الصمود والمقاومة في وجه الظروف المستحيلة، والثانية تمثل الإمكانية والأمل في بناء بديل حقيقي. ربما تكمن الحكمة في عدم اختيار إحدى القصتين على حساب الأخرى، بل في البحث عن طريقة لتحويل قوة الصمود المتجذرة في الخيام إلى استدامة البناء المتجسدة في الفصول الحديثة. فالسؤال ليس "تعليم أم كرامة؟" بل كيف نحوّل الكرامة في الصمود إلى كرامة في الفرصة، ونقل البذور المزروعة في رماد الحرب إلى بساتين تعليمية تحتضن كل طفل يمني بعدالة واستدامة.